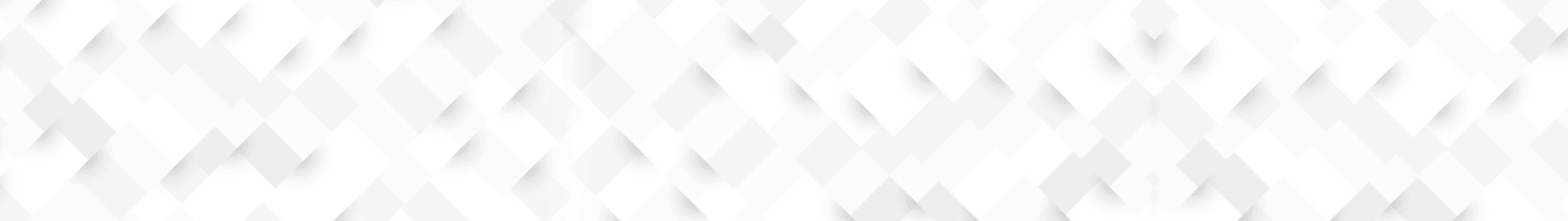في خضمّ التحوّلات المتسارعة التي تشهدها الإدارة العامة، يتقدّم الحديث عن الهياكل المرنة، والتقنيات الذكية، والنماذج التشغيلية الحديثة بوصفه العنوان الأبرز للرشاقة الحكومية. غير أن التجربة العملية، كما تُظهرها الوقائع والدراسات المقارنة، تكشف أن هذه العناصر – على أهميتها – لا تمثّل جوهر التحوّل بقدر ما تمثّل أدواته. أما نقطة الارتكاز الحقيقية لأي رشاقة مستدامة، فتظل الإنسان الذي يعمل داخل المنظومة، ويتفاعل معها، ويُنتج معناها اليومي.
فالسياسات تُراجع، والهياكل تُعاد هندستها، والتقنيات تتقادم، لكن الإنسان يظلّ الفاعل الوحيد القادر على التكيّف، والتعلّم، واتخاذ القرار في سياقات متغيّرة. ومن دون إعادة الاعتبار لدور الموظف الحكومي بوصفه شريكًا في صناعة القيمة العامة، لا مجرد منفّذ للتعليمات، تتحوّل الرشاقة إلى ممارسة شكلية تُغيّر الواجهة دون أن تُحدث أثرًا عميقًا في الأداء أو الثقة.
تنطلق الرشاقة الحكومية، في جوهرها، من فهم دقيق لطبيعة العمل الإنساني في البيئات العامة، حيث تتقاطع المسؤولية المهنية مع البعد الأخلاقي، ويتداخل الأداء الفردي مع المصلحة العامة. فالعمل الحكومي لا يجري في فراغ تقني، بل في سياق معقّد تحكمه اعتبارات العدالة، والإنصاف، وحساسية الأثر على المواطنين. لذلك، لا تُقاس كفاءة الموظف في الفريق الرشيق بمدى التزامه الحرفي بالإجراء، بل بقدرته على ممارسة الحكم المهني السليم، واتخاذ قرار مسؤول في ظل الغموض، والتفاعل الواعي مع احتياجات المستفيدين وتنوّعهم.
ومن هذا المنطلق، تعيد الرشاقة تعريف مفهوم الكفاءة الوظيفية ذاته، لتشمل مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتواصل، والتعلّم المستمر، والقدرة على التعامل مع عدم اليقين. وهي مهارات لا تُبنى بالأدلة الإجرائية وحدها، بل تحتاج إلى بيئة تنظيمية تسمح بالممارسة، وتحتضن الخطأ غير المتعمّد بوصفه مصدر تعلّم لا وصمة إخفاق.
هنا تبرز مسألة الأمان النفسي بوصفها شرطًا تأسيسيًا لنجاح أي فريق رشيق. فالثقافات التي تُجرّم الخطأ وتربط المساءلة باللوم الشخصي تُنتج سلوكًا دفاعيًا، يدفع الأفراد إلى الصمت، وتجنّب المبادرة، والالتزام بالحدّ الأدنى الآمن إداريًا. أما البيئات التي توفّر أمانًا نفسيًا منضبطًا، فتُمكّن الأفراد من التعبير، والتنبيه المبكر إلى المخاطر، ومناقشة البدائل، بما يرفع جودة القرار ويحدّ من الإخفاقات الصامتة.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الرشاقة عن نمط القيادة. فالقيادة الرشيقة ليست تلك التي تطالب بالمرونة، بل التي توفّر شروطها: وضوح في التفويض، وعدالة في المساءلة، واتساق في السلوك عند النجاح كما عند الإخفاق. وحين تُدار الأخطاء بوصفها فرصًا للفهم والتحسين، لا ذرائع للعقاب، يتحوّل الفريق من منفّذ حذر إلى شريك واعٍ في المسؤولية.
كما تعيد الرشاقة الاعتبار للدافعية الداخلية في العمل الحكومي. فحين يشعر العاملون بأن لجهدهم أثرًا ملموسًا، وأن ما يقومون به يتجاوز إنجاز المعاملة إلى خدمة الإنسان، يتعزّز الانتماء المهني ويتحوّل الالتزام من واجب وظيفي إلى قناعة داخلية. لذلك، لا تكتفي الفرق الرشيقة بتوزيع المهام، بل تحرص على ربط العمل اليومي بالقيمة العامة، وجعل الأثر مرئيًا للعاملين أنفسهم، لا للمستفيدين فقط.
وفي السياق الحكومي العربي، تكتسب مركزية الإنسان أهمية مضاعفة، نظرًا لإرث إداري طويل قائم على المركزية، والتسلسل الهرمي، والحذر المفرط في اتخاذ القرار. فالانتقال إلى فرق رشيقة لا يتحقق بتغيير المسميات أو إعادة رسم الهياكل، بل يتطلب تحوّلًا ثقافيًا في نظرة المؤسسة إلى موظفيها: من مورد يجب ضبطه، إلى طاقة يجب تمكينها؛ ومن منفّذ للوائح، إلى صاحب معرفة ميدانية وخبرة سياقية لا غنى عنها.
ويستدعي هذا التحوّل مراجعة سياسات الموارد البشرية نفسها، بما يشمل التوظيف القائم على الكفايات، والتعلّم المستمر، والتقييم العادل، ومسارات التطور المهني المرنة. فالفرق الرشيقة لا يمكن أن تعمل ضمن أنظمة تُكافئ الإنجاز الفردي المعزول، أو تُقيّد التعاون، أو تُخضع الأداء لمعايير جامدة لا تعكس طبيعة العمل الجماعي.
ويمتد وضع الإنسان في قلب الرشاقة الحكومية إلى بُعد أعمق يتعلق بإدارة الطاقة البشرية. ففي البيئات الضاغطة، غالبًا ما يُتجاهل أثر الإرهاق المزمن، وضبابية الأدوار، وتراكم الأولويات المتناقضة على جودة القرار والعمل الجماعي. أما الرشاقة الناضجة، فتنظر إلى هذه المسائل بوصفها قضايا تنظيمية لا فردية، وتُدير العمل عبر إيقاع واقعي، وتوزيع عادل للأعباء، ومساحات منتظمة للمراجعة والتغذية الراجعة.
كما تضع الرشاقة الإنسان في موقع الفاعل الأخلاقي داخل منظومة الخدمة العامة. فالمرونة في اتخاذ القرار لا تعني التفلت من القيم، بل تتطلب وعيًا أخلاقيًا أعلى، لأن غياب القوالب الجامدة يُحمّل الأفراد مسؤولية تقدير الأثر، وتجنّب الإقصاء غير المقصود، وتحقيق الإنصاف. وفي هذا الإطار، تتحوّل القيم المؤسسية من شعارات مُعلّقة إلى مرجع عملي يُحتكم إليه في النقاشات اليومية.
وفي زمن تتسارع فيه الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تتأكد حقيقة جوهرية: أن الرشاقة لا تهدف إلى تقليص دور الإنسان، بل إلى تعظيمه. فكلما تحرر من الأعمال النمطية، ازدادت الحاجة إلى مهاراته الإنسانية التي لا تُستبدل: الحكم المهني، والفهم السياقي، والتعاطف، واتخاذ القرار الأخلاقي. وهنا، تصبح التكنولوجيا اختبارًا لنضج المؤسسة في إعادة توزيع الأدوار دون تفريغ الإنسان من معناه.
وفي المحصلة، فإن وضع الإنسان في قلب الرشاقة الحكومية ليس خيارًا تنظيميًا تجميليًا، بل شرطًا بنيويًا لنجاح أي نموذج رشيق. فالمؤسسات التي تتجاهل هذا البعد قد تتحرك بسرعة، لكنها تظلّ عرضة للتآكل من الداخل. أما تلك التي تستثمر في إنسان واعٍ، ممكَّن، ومتعلّم، وقادر على التعاون وتحمل المسؤولية، فهي التي تؤسس لشرعية مؤسسية أعمق، وثقة مجتمعية أعلى، وقدرة حقيقية على مواجهة المستقبل بتوازن وحكمة.
د. كفاية محمد عبد الله
رئيس قسم سياسات الخدمات الحكومية
هيئة الخدمة والإدارة العامة
المملكة الأردنية الهاشمية
2 فبراير 2026